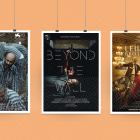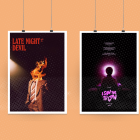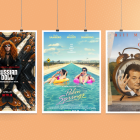فن
شاعرية الحياة العادية
«ربما تعافيت قليلاً من رمد القلب وانتبهت لأول مرة إلى أن حياتنا العادية هي المادة الخام للجمال والخيال ولأفلام عاطف الطيب..»
 صورة تعبيرية (شاعرية الحياة العادية)
صورة تعبيرية (شاعرية الحياة العادية)
أول نظرة للبحر من بعيد من شباك السيارة على طريق المصيف، فرحة القلب ببراح البحر والمدى المفتوح، في كل مرة من مرات السفر كنت أتحمس لهذه النظرة الأولى وأعتبرها من أجمل ما في المصيف. وفي أحد الأعوام نظرت للبحر من نفس النقطة على الطريق، كان البحر على عادته. تأثر كل من في السيارة معي نفس التأثر المتكرر كل عام، أما أنا فلم أشعر بشيء. وتوقف قلبي عن الشعور بالجمال البسيط. أذكر أنني حينها أغمضت عيني لأكثر من مرة آملاً أن أستعيد التأثر عند فتح عيني لكن دون جدوى. ما كان يسعدني قبل الآن لم يعد يؤدي دوره.
كانت هذه أول تجربة لي من عدم التأثر بما كنت أفرح به مسبقاً. بعد الرجوع من المصيف شُخِّصت بالاكتئاب الحاد في أول جلسة لي مع الطبيب النفسي، وعلى الرغم من توقعي لهذا الأمر، فإنني وددت لو أن الطبيب خالف ظني وأخبرني أن كل شيء على ما يرام! فيما بعد تابعت مع أكثر من طبيب -بحكم تغيير مكان ومدينة إقامتي أكثر من مرة - وكلهم نصحوني بأن أكتب لنفسي، وأكدوا أن هذا التدريب مفيد للسيطرة على الأفكار السلبية، وفي إحدى هذه الرسائل اقتبست عن محمود درويش ما شعرت به حينها وما أصبح شعوراً عاماً لسنوات:
«القلب يصدأ كالحديد
فلا يأن ولا يحن
ولا يُجن بأول المطر الإباحي الحنين
ولا يرن كعشب آب من الجفاف
كأن قلبي زاهد
أو زائد عني
كحرف الكاف في التشبيه».
بعد ذلك بفترة وجيزة انتهت آلام والدتي من سرطان العظام وتوفيت إلى رحمة الله، لكني لم أستطع البكاء عليها، وبعد عودتي للبيت من الدفن نهرتني أختي الكبرى على عدم بكائي؛ فأخبرتها أنني لا أتظاهر بالصبر أو التماسك؛ لكني بالفعل لا أستطيع البكاء وكأن عيني صارت من زجاج. بعدها بأشهر كنت أحن إلى أمي، وشيئاً فشيئاً بكيت كثيراً، وبدأت أتحسن عندما توقفت عن لوم نفسي.
تحت الملاحظة
مع العلاج الدوائي والجلسات تحسنت حالتي كثيراً، وتقدمت للتجنيد الإجباري وكنت جاهزاً لأداء فترتي، وأثناء انتظاري لإجراء الكشف الطبي وأنا مصطف مع الكثير من العرايا إلا من قطعة من الملابس الداخلية - في مشهد يعرفه كل ذكر مصري - نظرت أمامي فوجدت ملصقاً كبيراً مكتوباً في وسطه من الأعلى «التلقين الطبي»، وهو إعلان بالحالات الطبية التي يُعفى صاحبها من التجنيد، قرأته لآخره بداعي الفضول، فإذا في السطر الأخير منه: «من كان يعاني من المرض النفسي، مثل … والاكتئاب». يا فرج الله ها هي شهادة الإعفاء تلوح في الأفق، لكن سريعاً ما أتت الرياح بما لا أشتهي.
وانتقلت إلى مركز التدريب؛ لأني لم أستطع إثبات ما أعاني منه بورقة رسمية، ونصحني البعض بالتظلم في وحدتي بعد التوزيع، وهو ما فعلته؛ لكن حتى تتأكد الجهات الرسمية من ادعائي أخبروني أن الإجراء المتبع هو دخول مدعي المرض النفسي لمشفى الخانكة للأمراض النفسية لعدة أسابيع تحت الملاحظة، والخروج بتقرير يُحدَّد بِناءً عليه صدق الادعاء من عدمه.
لأكثر من ثلاثة أسابيع مكثت في الخانكة تحت الملاحظة، ورغم أن حالتي كانت أكثر استقراراً في هذه الفترة، فإن الأطباء الثلاثة الذين لاحظوني كتبوا في تقريرهم الأخير: «يعاني من اكتئاب جسيم»، لا أعرف هل تمكنت من إتقان الدور لهذه الدرجة، أم أن الاكتئاب هو الذي تمكن منَّي. لم تكن فترة احتجازي في الخانكة على وتيرة واحدة، وكانت الأيام الأولى هي الأصعب.
وصلت إلى قاع الفشل مفلساً غير مستقر في حياة مهنية أو عاطفية، يتحكم في جسدي مجموعة من محبي التسلط على أجساد البشر من الممرضين. شعرت بالمهانة والعار، ليس لأنني في مشفى للأمراض النفسية والعقلية، بل لشعوري بعجز الميت عن السيطرة على حياتي. كان الوقت يمر بطيئاً ولا شيء أملكه سوى الذكرى التي كانت سيئة غالباً. عدت حينها لما أبرع فيه من جلد الذات، وتذكرت تفاصيل كل فرصة أهدرتها. لكن بعد الوصول للقاع، لم يكن ثَم مكان آخر يمكن الذهاب إليه، وهو ما جعلني أتأمل مأساتي لأضع حلاً لما أنا فيه؛ فكانت الأيام التالية في الخانكة إجازة لي للتفكير فيما مضى وما سيأتي.
وصلت حينها إلى بداية رحلتي الفعلية في العلاج عندما أدركت أن هذا القاع الذي أوصلت نفسي إليه كان من إبداعي قبل كل شيء. رسمت هذا القاع في ذهني، ثم ساقني قلقي وإحباطي إليه. وكما تقول الحكمة القديمة: «خذ الحكمة من أفواه المجانين»، فأنا الآن لست بينهم فحسب، بل إنني عملياً واحد منهم.
تعرفت في الخانكة على ه، شاب ثلاثيني يعمل نجار موبيليا، استغل أخوه معاناته مع المرض النفسي واستدعى له رجال مشفى الخانكة لاحتجازه طمعاً في الورشة التي ورثاها عن الوالد. بالإضافة للأستاذ ع. ا، الذي كان يعمل باحثاً في العلوم السياسية، واحتُجز في الخانكة نكايةً من أحد الضباط. على تنوع القصص واختلافها كلنا كنا نفتقد حياتنا في الخارج، على الرغم من أن أياً منا لم تكن حياته مترفة، وخلفياتنا الاجتماعية تكاد تكون واحدة من متوسطي الحال، إلا أننا جميعاً كنا نفتقد حياتنا في الخارج، وكأن الخارج هذا جنة على الأرض.
وحتى لا تقع عزيزي القارئ في الإسقاط والتعميم، فإن المشفى النفسي رغم مشابهته للسجن فإن ما افتقدناه في الخانكة ليس هو تحديداً الشعور بالحرية والنظر إلى السماء بدون سقف - هنا تختلف المشافي النفسية عن السجون فهامش الحرية بها أكثر قليلاً أو على الأقل هكذا كانت تجربتي - ما افتقدناه في الخانكة هو الشعور بالاستقرار والحنين إلى أن كل شيء على ما يرام، افتقدت كثيراً أن ألاحظ أنا حياتي، لا أن أكون تحت الملاحظة.
أذكر أنني أخبرت حينها زوجتي أنني أفتقد جلسة على أحد المقاهي ومشاهدة الناس يروحون ويجيئون. لأول مرة أدركت قيمة الحياة العادية، كان ه يحكي وهو يدرك ربما لأول مرة قيمة ورشته الصغيرة وقيمة مهارة يده، مثلما كان ع. ا يحكي بالكثير من السعادة عن حياته المستقرة وبيته الذي خرب على إثر اعتقاله ثم إيداعه في الخانكة.
نفس الأمور التي لم تكن تسعدني كثيراً قبل الدخول للخانكة أو كنت أفعلها انتظاراً لأي تأثير إيجابي بدون جدوى، أصبحت الآن أحن إليها وأرجو أن أخرج من هنا لأقوم بها، أدركت أخيراً أن حياتي العادية بلا شك حياة مثالية في عين مريض أو مبتور الأطراف أو مسجون ينتظر حريته أو محتجز في مشفى الخانكة. ربما تعافيت قليلاً من رمد القلب وانتبهت لأول مرة إلى أن حياتنا العادية هي المادة الخام للجمال والخيال ولأفلام عاطف الطيب.
بمَ التعلل؟! الحياة العادية
في قصيدة بها الكثير من الحكمة يقدم المتنبي بعضاً من فلسفته في الحياة فيقول:
«لا تلق دهرك إلا غير مكترث
ما دام يصحب فيه روحك البدنُ»
الحياة العادية فقط بعيداً عن شاعريتها هي أن تلقى دهرك غير مكترث ما دامت حياتك عادية مستقرة، وبالتأكيد يصاحب فيها روحك البدن، في مطلع نفس القصيدة يتساءل المتنبي باستنكار بمَ التعلل؟ لكن لنسأل بشكل حقيقي بمَ التعلل؟ وما الدافع الذي يمكن أن يتكئ عليه مريض اكتئاب؟
بعد خروجي من الخانكة بدأت العمل في مجال الطهي، ولأول مرة منذ سنوات كان يومي ينتهي بدون طوفان من التفكير في الماضي والمستقبل والوجود وكيف بدأ الخلق؟ يوم عادي ونوم عميق بعد مجهود بدني مرهق. أعتقد أن المفهوم الشعبي عن الستر لا يختلف كثيراً عما أقصده بالحياة العادية. ولا تختلف عنهما الكلمة المأثورة عن حكماء العرب من أن «الغنى هو الاكتفاء بالموجود والاستغناء عن المفقود».
بعد أن فقدت أماني النفسي وسط سيل الرغبات غير المجابة، حاولت تقليل تلك الرغبات أو التأكد من صحتها والإجابة عن سؤال هل أنا حقاً محتاج لهذه الرغبة؟ النزوع إلى الكمال رغبة سخيفة تصيب الشخص بالتوقف عن استخدام الحياة، والتردد بين الكمالات المتخيلة أقعدني في مكاني لسنوات. لم أطور بعد طريقة للتعامل مع التردد أفضل من أن يكون الاختيار بناءً على المعيار الأخلاقي. إذا اخترت طريقاً بناءً على أنه أخلاقي أكثر من طريق آخر؛ فأنا بذلك أحاول أن أبني مشاعر إيجابية مع اختياري، وهو ما يساعد على الإحساس بالجمال/ اللذة تجاه حياتي العادية.
تماماً كما نشعر بالجمال تجاه المنظر الطبيعي، «فلكي نرى المنظر الطبيعي جميلاً يتحتم علينا أن نحبه نحن، ولكي نحبه ينبغي لنا أن نضفي عليه مدلولاً خلقياً»،[1] وهذا هو السبب وراء تأثر ابن المدينة بمنظر طبيعي ريفي أكثر من ابن الريف نفسه؛ لأن الأول ربما يرى في المساحة الشاسعة من اللون الأخضر والبساطة معنًى من معاني الخير يفتقده مع قبح المدينة، أما الثاني فهو ربما لا يرى إلا قرية معدمة يرجو الهرب منها، لذلك فإن غالبية الناس «لا يعنُّ لهم أن في الإمكان تأمل العالم العادي الذي يعيشون فيه كل يوم تأملاً جمالياً»،[2] وكذلك الحال بالنسبة لحياتنا العادية.
لكن ما الحل إذا قللنا رغباتنا وتركنا المزيف منها وتمسكنا بالحقيقي فقط وأضفنا الطابع الأخلاقي ثم فشلت الخطة مرة أخرى؟ في الحقيقة كان القرد نفع نفسه، وهذه السطور بالتأكيد ليست خطة للنجاح! لكنها تجربة طورت فيها دفاعي أمام الإحباط وخيبة الأمل. والإجابة عن السؤال هي أن تبدأ من جديد!
صدق التجربة
لما مات والد امرؤ القيس وكان القتلة أصحاب جيش ودولة، أراد شاعرنا السفر لقيصر ليطلب جيشاً منه يستعين به في الثأر لأبيه، ولطول المسافة ومشقتها واحتمالات رفض القيصر نصرة الرجل، وربما لما هم فيه من موقف لا يحسدان عليه، بكى رفيق امرؤ القيس في السفر، فقال الشاعر:
«بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه
وأدرك أنَّا لاحقان بقيصرا
فقلت له لا تبكِ عينك إنما
نحاول ملكاً أو نموت فنعذرا»
هكذا فإن عذرك المشرف الوحيد بعد أي تجربة فشلت فيها عن تحقيق هدفك هو أنك حاولت وسعيت بكل جهدك حتى تقطع كل عذر. شكَّلت هذه القناعة دفاعي الأخير ضد أفكار الانتحار، وآمل ألا ينهار هذا الدفاع يوماً ما.
ما أجده شاعرياً في حياتنا العادية هي أن كلاً منا يحاول أمراً ما ستحمد عاقبته في نهاية الأمر، أو يموت فيعذر لأنه حاول بكل الطرق وبكل قوته. قصة كل واحد منا ملهمة بما يكفي أن يقتبس منها الروائي والسيناريست والمصور. «ولو استطعنا أن نعرف أنفسنا؛ لعرفنا أيضاً أين توجد سعادتنا التي تنتمي حقيقة إلى طبيعتنا»،[3] هكذا يمكن أن نفهم لماذا يجرب البعض نفس الشيء عشرات أو مئات المرات بدون ملل، وذلك لأنهم وجدوا أنفسهم، «إن الفكر الواضح والإيمان العميق الذي ينتج عن التجربة الصادقة من ممتلكات الإنسان الخالدة».[4]
أخيراً في وقت بكائك سيظهر الحشيش كرفيق رائع، لكني أؤكد لك - وأنت تدرك هذا! - أن الحشيش مع الوقت يفقد مفعوله، وما كنت تتعاطاه ليبقيك نشطاً أو ملاحظاً لجمال الحياة العادية في عصير القصب! سريعاً ما ستتعاطى أضعافه ولن يشعرك بأي شيء سوى أنه يفتح لك باباً للنسيان، وبعد أن كنت تشرب لتركز في العمل أو للتفكير في حل مشكلة ما، أصبحت تشرب لتنسى أي عمل أو مشكلة، ومع كثرة الهرب تتراكم المشكلات وتتفاقم وتفقد صدق التجربة.